التخطيط الاستراتيجي المعرفي: حين تكون العقول أول الأصول
مقال تحليلي يستعرض الأنماط البشرية في التعامل مع المعرفة ويكشف كيف يمكن للدول بناء استراتيجيات اقتصادية فعالة تبدأ من تكوين الإنسان المعرفي القادر على الإنتاج، الربط، والتسخير، بما يعزز التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.
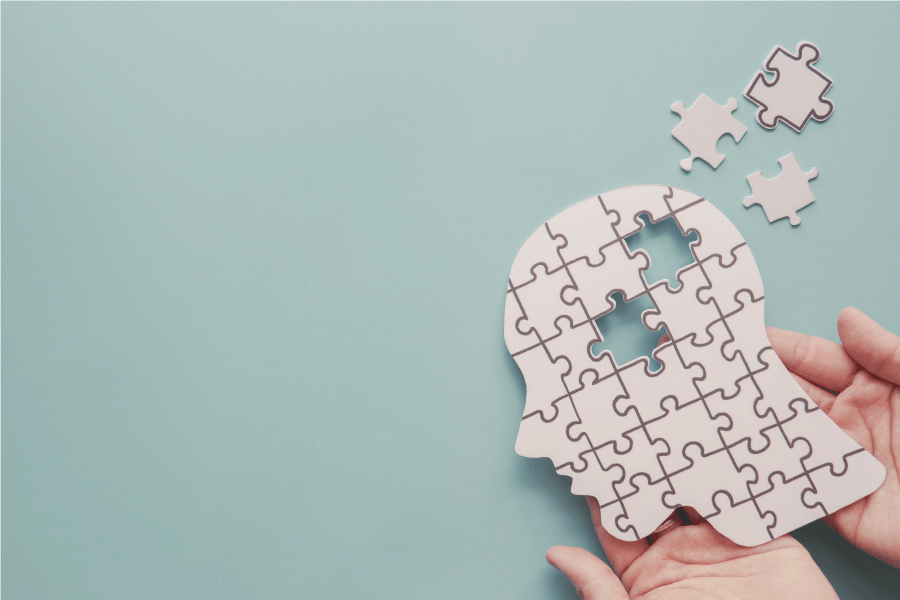
المعرفة بين القيمة والانبهار: أنماط الإنسان في زمن فائض المعلومة
حين يُصبح الناقل هو النجم والمنتِج في الظل
في زمن تتساقط فيه المعلومات كما تتساقط أوراق الخريف من كل زاوية رقمية، وتتنافس الشاشات على بثّ المعرفة كما يتنافس الهواء على ملء الرئتين، يغدو من المشروع – بل من الضروري – أن نتوقف قليلًا لنسأل: ما الفرق بين من يعرف ومن يستعرض المعرفة؟ بين من ينتج الفكرة ومن يتغنى بها؟ وبين من يربط المعرفة بمنفعة، ومن ينثرها دون معنى؟
لقد آن الأوان أن نُفكك هذا المشهد الضبابي، ونُعيد تصنيف الفاعلين فيه؛ لا وفق شهرتهم أو متابعيهم أو بلاغة تغريداتهم، بل بناءً على نوع العلاقة التي تربطهم بالمعرفة: هل هي علاقة إنتاج؟ نقل؟ تسخير؟ أم مجرد اجترار وتزيين؟
في قلب هذا المشهد، يمكن تمييز أربعة أنماط إنسانية تتعامل مع المعرفة، كلٌّ منهم يُمثل دورًا متمايزًا – وإن تداخلت الأزياء أحيانًا على مسرح السوشيال ميديا
منتِج المعرفة:
ذاك الذي لا يُطربه التصفيق، بل تُشغله الأسئلة التي لم تُطرح بعد، وتؤرقه الفجوات التي لم تُملأ. هو الشخص الذي ينحت المفاهيم من قلب التجربة، ويعيد ترتيب الأبنية المعرفية كما يُعاد ترميم المعابد المنسية. لا يُبهره عدد القراء، بل يُسعده أن يرى فكرةً وُلدت من عقله تنتقل إلى عقلٍ آخر، في بيئة أخرى، وتُثمر في سياق ثالث.
منتِج المعرفة لا يسرق الضوء، بل يُضيء مساحات كانت ميتة. يخلق معرفة جديدة، لا من أجل التفاخر بها، بل لاستثمارها، لحمايتها، لبيعها كقيمة، لا كزينة. هو رائد الاقتصاد المعرفي، لا الناقل المتذاكي، ولا المتفاخر بكتب لم يفهمها.
ناقل المعرفة:
الوجه الأكثر لمعانًا في زمن الإعلام المتضخم. هو من يحفظ ويكرر، يقتبس ويعيد الصياغة، يلمّع المفردات ويعجنها بعاطفة جماهيرية، حتى تبدو أعمق مما هي عليه.
الناقل لا يخلق جديدًا، بل يُجيد التقاط ما يثير الانتباه، ويُقدّمه بلبوس الفهم، بينما هو – في عمق الأمر – لا يعي ما ينقل، ولا يُدرك سياقه، ولا يُحسن استخدامه.
وهو أكثر الأنماط رواجًا في المشهد الرقمي: مؤثرون، صانعو محتوى، قرّاء سطحيون يُبرعون في صناعة الانبهار، لا الأثر.
نُصفّق لهم كثيرًا، نُتابعهم بإخلاص، ونبني آمالنا على ما يقولونه، دون أن نُدرك أننا أمام معرفة مشذبة، منزوعة الجذور، تُخدّر وعينا أكثر مما تُنيره.
رابط المعرفة:
هو نمط مختلف، لا يُغرق نفسه في تخصص واحد، بل يجوب الحقول الفكرية كما يجوب النحل الأزهار، يجمع الرحيق من هنا وهناك، ليصنع توازنًا بين الفهم والتطبيق.
هو الذي يرى في الفيزياء تفسيرًا للفن، وفي علم النفس أداة لفهم التسويق، وفي الفلسفة بوابة لإعادة هندسة التعليم.
رابط المعرفة لا يكتفي بالنقل، بل يربط، لا يُعيد التكرار، بل يُعيد التشكيل، ويُخرِج من المعارف المبعثرة منتجًا مركبًا يُناسب حاجةً اقتصادية أو اجتماعية.
هؤلاء هم من يصنعون الجسور بين العوالم الفكرية، وهم عملة نادرة في المؤسسات التي تتوق لتجديد رؤاها دون أن تفقد جذورها.
مُسخّرو المعرفة... حين تتجسّد الفكرة في منتج يمشي بين الناس
إذا كان منتج المعرفة هو من يحفر في العمق ليستخرج فكرةً جديدة، وكان ناقل المعرفة هو من يلتقط هذه الفكرة ليعيد عرضها بلغة الجموع، وكان رابط المعرفة هو من يجسر الفجوات بين العوالم، فإن النوع الرابع – الأندر والأكثر أثرًا – هو مُسخّر المعرفة: ذاك الذي لا يكتفي بفهم الفكرة أو ربطها، بل يلبسها جلدًا ويمنحها وظيفة، فيُحوّلها إلى منتج، خدمة، مشروع، أو حلّ يُنقذ مؤسسة، يُحدث تحوّلاً، أو يُصنع اقتصادًا جديدًا.
مُسخّر المعرفة لا يعمل في الظل، لكنه لا يتغذّى على الأضواء. يُشبه المخترع، لكن ذهنه أوسع من المختبر؛ يُشبه رائد الأعمال، لكن جذوره أعمق من السوق؛ ويُشبه الفيلسوف العملي، ذاك الذي يقرأ كتب المعرفة لا ليحفظها، بل ليُحرّرها من سجن المفاهيم النظرية إلى ميدان الفعل الإنساني.
هو الذي يفهم أن كل فكرة لا تترجم إلى أثر، هي مجرد رفاه لغوي. وأن كل معرفة لا تُنتج حلاً، هي عبءٌ إضافي على الذاكرة البشرية.
لا يُغريه جمع المراجع، بل يحفّزه اكتشاف إمكانية تحويل دراسة سوسيولوجية عن العزلة، إلى منصة تقنية تربط العزّال ببعضهم. ولا يُثيره النقاش حول الفروقات بين المدارس التربوية، بقدر ما يسأله ضميره: كيف أصنع نموذجًا تربويًا يجمع بين المنهج والبساطة، بين الأصالة والتطبيق؟
مُسخّر المعرفة يفهم السياق قبل الفكرة، ويقرأ السوق قبل أن يقرأ العنوان، ويقيس الأثر قبل أن يحتفل بالكم.
فهو يرى في المعرفة مادة خام، لكنه لا يقدّسها في شكلها الخام، بل يُعيد تشكيلها لتصبح منتجًا اجتماعيًا واقتصاديًا وإنسانيًا.
هو من يُحوّل كتابًا إلى منصة تعليم، ورؤية فلسفية إلى منتج سلوكي، وخريطة مفاهيم إلى خريطة استثمار.
لا يخشى تبسيط المعقد، لأنه يعلم أن الفكرة حين تُسجن في جدران النخبة، تموت مختنقة في حضن الكبرياء المعرفي.
فجوة الانبهار والاستخدام
في مجتمعاتنا، يندر أن يُحتفى بهذا النوع؛ لأن الخطاب العام ما زال أسير "ناقل المعرفة"، ذلك الذي يُتقن فنون الإبهار أكثر من أدوات البناء. ننبهر بمن يحفظ أسماء النظريات، لا بمن يصنع منها واقعًا. نتابع من يُردد جُملاً عميقة، لا من يُبسّطها لتصبح سلوكًا.
والنتيجة؟ فائض في الكلام، عجز في الحلول. محتوى يُشبه زخرفة معمارية على جدار آيل للسقوط. وعي سطحي ناتج عن إدمان شكل المعرفة، لا وظيفتها.
في حين أن مُسخّر المعرفة هو من يحمل مفاتيح القفزة الحضارية: هو الذي يخلق من التعليم صناعة، ومن السلوك اقتصادًا، ومن الملاحظة اليومية منتجًا ابتكاريًا.
وإذا كانت الدول تُقاس بمواردها الطبيعية، فإن المجتمعات المتقدمة تُقاس بعدد من نجحوا في تسخير المعرفة لا مجرد تداولها.
المعرفة كقوة استراتيجية: من التنظير إلى التكوين الاقتصادي
حين تصبح أنماط المعرفة محور التخطيط الاستراتيجي للدولة
في زمن تتصارع فيه الدول لا على الموارد الطبيعية، بل على العقول القادرة على تحويل المعلومة إلى ميزة، والفكرة إلى قيمة، تصبح المعرفة – لا النفط ولا المال – هي الأصل الاستراتيجي الجديد. ومع هذا التحول البنيوي، لم يعد كافيًا أن تُدرج "الابتكار" في الخطط الوطنية كشعار، بل يجب أن يُصاغ التخطيط الاستراتيجي انطلاقًا من سؤال جوهري: أي نوع من البشر المعرفيين نريد أن نصنع؟
ذلك أن كل اقتصاد معرفي ناجح لا يقوم على مجرد جمع البيانات أو استيراد الأفكار، بل على تكوين وتغذية أنماط معرفية محددة تُنتج وتربط وتُسخّر المعرفة، لا تكتفي بنقلها.
وهنا تتضح المسافة الفاصلة بين التخطيط الشكلي والتخطيط الاستراتيجي الحقيقي. الأول يضع أهدافًا على الورق، والثاني يبني نماذج بشرية تحقق تلك الأهداف. الأول يهتم بمؤشرات الأداء، والثاني يهتم بمن يُنجز الأداء فعلًا، وبأي أدوات.
وبحسب هذا الفهم، فإن الدول التي تسعى إلى نهضة حقيقية، وتُحسن تنفيذ استراتيجياتها بعيدًا عن الجلبة الإعلامية أو زخارف الرؤى، عليها أن تُعيد ترتيب أولوياتها المعرفية على النحو التالي:
الاستثمار في مُنتجي المعرفة
هؤلاء هم حجر الأساس. لا بد أن يُشكّلوا الفئة الأكثر رعاية وتمكينًا، لأنهم المصدر الأصلي لكل تحول علمي أو تقني.
ينبغي أن تُصمم البرامج البحثية والسياسات التحفيزية لتدعمهم، لا أن تُخضعهم للبيروقراطيات العقيمة.
ويجب أن يُنظر إليهم لا كمجرد باحثين أكاديميين، بل كـ"روّاد معرفة"، تُبنى عليهم منتجات، وتُستثمر فيهم صناعات، وتُصاغ بهم استراتيجيات وطنية.
تمكين مُسخّري المعرفة كمحور التنفيذ
إذا كان مُنتج المعرفة هو من يكتب الخطة، فإن مُسخّرها هو من يُجسّدها في منتج، في منصة، في حلّ.
هم الجسر بين التخطيط والواقع، وهم جوهر تنفيذ الاستراتيجيات الفعلية.
دونهم، تبقى الأفكار الجميلة حبيسة الوثائق، ويبقى النموذج الاقتصادي فاقدًا للقيمة المضافة.
الدولة التي تُدرك هذا، لا تضع سياسات تعليمية فقط، بل تُنشئ منصات تسخير معرفي، تربط الجامعات بالمشاريع، والمختبرات بالأسواق، والباحثين بالمستخدم النهائي.
احتضان روابط المعرفة كصناع آفاق جديدة
رابطو المعرفة هم من يُخرجوننا من أسر التخصصات الضيقة، وهم من يُعيدون تشكيل القيمة عبر المزج الذكي بين الحقول.
لا يُنتجون بالمعنى التقليدي، لكنهم يُعيدون تعريف الفائدة.
إنهم صُنّاع المسارات الجديدة في التعليم، في الصناعة، في الصحة.
لذا يجب أن يُدمجوا ضمن استراتيجيات الابتكار، لا كمكمّلات، بل كعناصر تصميم أساسية في التفكير التنموي.
ضبط مساحة ناقلي المعرفة دون التضخم بهم
لا نقول بإقصائهم، فهم ضرورة إعلامية وتثقيفية، لكنهم ليسوا مركز التخطيط، ولا أدوات التنفيذ.
الدول التي تجعلهم واجهتها الفكرية تُخدر وعيها من حيث لا تدري.
فلا أحد يبني اقتصادًا بالاقتباس، ولا يبتكر بالمحتوى المعلّب، مهما بدت جمله لامعة.
الإنسان المعرفي أولًا... ومن بعده يأتي كل شيء
حين ننظر إلى التاريخ بعين الناقد، وإلى الواقع بعين المفكّر، وإلى المستقبل بعين الاستراتيجي، نُدرك أن الأمم لم تصعد بفعل وفرة الموارد، ولا بغزارة الأمنيات، بل بصناعة نمط معيّن من الإنسان: إنسان يُنتج المعرفة، لا يقتبسها فقط؛ يُسخّرها، لا يُجمّلها؛ يُحرّكها في السوق، لا يُدوّرها في المجالس.
وفي ضوء هذا الفهم، يصبح السؤال الأهم ليس: ما خطتنا الخمسية؟ بل: من هو الإنسان الذي ستُنتجه هذه الخطة؟
لقد عرّفنا في هذا المقال أربع شخصيات معرفية تتماوج داخل المشهد المعرفي المعاصر:
-
منتج المعرفة: صانع المفهوم والجذر.
-
ناقل المعرفة: مؤدّي المعنى دون عمقه.
-
رابط المعرفة: مَن يبني الجسور بين العوالم.
-
مُسخّر المعرفة: الذي يُحوّل الفكر إلى قيمة محسوسة.
وإذا أردنا أن نبني اقتصادًا لا ينهار بانخفاض سعر النفط، ومجتمعًا لا يتقلّب مع نغمة كل مؤثر رقمي، فعلينا أن نُعيد تشكيل خرائطنا التنموية، لا على أساس القطاعات، بل على أساس أنماط العقول التي تُدير هذه القطاعات.
إن التخطيط الاستراتيجي الحقيقي لا يبدأ من الرؤية، بل من نوع العقول التي تُفكّر في الرؤية.
وتنفيذ الاستراتيجيات لا يعتمد فقط على البرامج الزمنية، بل على البشر الذين يحملون قدرة الربط والتسخير والتحويل.
ولذلك، على الدول أن تُغلق صنبور الانبهار بالناقلين، وتفتح حواضن جديدة للمنتجين، وأن تُعيد الاعتبار لمُسخّري المعرفة كأدوات تنفيذ حقيقية، لا مجرد ملحقات فكرية.
فلا أمة تُبنى بمن يُصفّق للأفكار، بل بمن يصنع منها منتجًا.
ولا مستقبل يُصاغ بمَن يُقلّد المفاهيم، بل بمن يُعيد ابتكارها.
وكل خطة لا تسأل: أي نوع من الإنسان سنُخرّج؟، هي خطة معطوبة، مهما بدت أنيقة، ومهما ازدانت بالشعارات.
المعرفة ليست خيارًا ثقافيًا، إنها خيار وجود استراتيجي. ومن لا يُحسن صناعته، لا يُحسن البقاء.




















