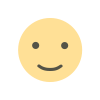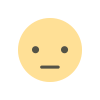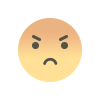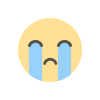جائزة نوبل: الحكاية الكاملة لجائزة نوبل منذ عام 1901
رحلة عميقة في تاريخ جائزة نوبل منذ نشأتها على يد ألفرد نوبل وحتى حاضرها، تكشف كيف تحوّلت من وصية شخصية إلى معيار عالمي للعلم والضمير، وكيف أعادت جائزة الطب والفسيولوجيا رسم خريطة الإنسانية عبر اكتشافات أنقذت الحياة وغيّرت فهمنا للجسد والمرض.

في نهاية القرن التاسع عشر، وقف ألفرد نوبل، العالم والمخترع السويدي الذي غيّر وجه الصناعة باختراعه الديناميت، أمام مرآة التاريخ، يقرأ في الصحف نعيه الخاطئ الذي نُشر قبل وفاته الفعلية بعناوين قاسية مثل "تاجر الموت". كان ذلك الحدث صدمةً هزّت ضميره، إذ أدرك أن إرثه العلمي قد يُذكر لا كإبداعٍ بنّاء، بل كرمزٍ للدمار.
في وصيته الأخيرة، أوصى نوبل بتخصيص معظم ثروته لتأسيس صندوق استثماري تُوزّع أرباحه على جوائز سنوية تُمنح لمن قدّم للبشرية أعظم فائدة. لم يكن يريد أن تُكافأ العبقرية المجردة، بل تلك التي تُترجم إلى نفعٍ ملموس للإنسان. ومن هنا جاءت الجوائز في مجالات الفيزياء، الكيمياء، الطب أو الفسيولوجيا، الأدب، والسلام، ثم أُضيف الاقتصاد لاحقًا عام 1968 بمبادرة من البنك المركزي السويدي.
منذ عام 1901، تحوّلت جائزة نوبل إلى مرجعٍ أخلاقي وعلمي في آنٍ واحد، فهي لا تقيس العبقرية بالشهرة، بل بالأثر. لم تكن الجائزة تكريمًا لحظةً من المجد فحسب، بل وعدًا بتوجيه المعرفة نحو الخير العام. و
الأكاديميات واللجان النوبلية
يتولى الإشراف على الجائزة عدد من الهيئات العلمية والأكاديميات المتخصصة في السويد والنرويج، لكل منها دور محدد في منح الجائزة ضمن مجالها. ففي الطب أو الفسيولوجيا، تقع المسؤولية على معهد كارولينسكا (Karolinska Institutet) في ستوكهولم، أحد أعرق المراكز الطبية في أوروبا. ومن داخل هذا المعهد تعمل لجنة علمية تُعرف باسم اللجنة النوبلية للطب، وهي المسؤولة عن عملية الاختيار.
تبدأ القصة كل عام حين ترسل اللجنة دعوات سرية إلى آلاف العلماء وأعضاء الأكاديميات حول العالم، تطلب منهم ترشيح من يرونه أهلًا للجائزة. ولا يُقبل أي ترشيح يأتي من خارج هذه الدائرة المختارة بعناية، لأن فلسفة نوبل كانت واضحة: الجائزة يجب أن تُمنح لمن يعرفه العلم لا الإعلام.
تصل الترشيحات عادة في يناير، لتبدأ بعدها رحلة المراجعة الطويلة، حيث تُشكّل فرق بحث متخصصة تدرس كل إنجاز علمي بعمق، تُراجع أوراقه المنشورة، وتتحقق من نتائجه التجريبية، وتستشير خبراء دوليين دون الكشف عن هوية المرشحين. تستمر هذه العملية لأشهر، في صمتٍ تام، حتى تصل اللجنة إلى قرارها النهائي عادة في سبتمبر، ثم يُعلن اسم الفائز في الأسبوع الأول من أكتوبر وسط اهتمام عالمي.
هذه المنظومة الصارمة ليست مجرد تقليد بيروقراطي، بل درع يحمي الجائزة من الانحياز ويصون قيمتها الرمزية. فأن تُمنح جائزة نوبل لا يعني أنك عالمٌ مبدع فقط، بل أنك أضفت سطراً خالداً في سجل الإنسانية، بعد أن مرّ عملك عبر أدق عمليات التحكيم العلمي في التاريخ الحديث.
هكذا تُمارس العدالة في صمت، بعيدًا عن الأضواء، داخل غرفٍ مغلقة في ستوكهولم، ليخرج في النهاية اسم واحد يمثل لحظة من النقاء العلمي في عالمٍ يميل غالبًا إلى الضجيج.
الإعلان والاحتفال والرمزية
في أوائل أكتوبر، تتجه أنظار العالم إلى قاعة صغيرة داخل معهد كارولينسكا، حيث يجلس عدد من العلماء بملامح متزنة وعيون حذرة أمام صفٍ من الكاميرات. لا موسيقى، لا مؤثرات، ولا وعود مسبقة. فقط ورقة واحدة تحمل اسماً سيُضاف بعد دقائق إلى تاريخ البشرية. تلك اللحظة هي ذروة العام العلمي، لحظة إعلان جائزة نوبل.
تُعلن جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب عادةً في الاثنين الأول من شهر أكتوبر، لتكون فاتحة “أسبوع نوبل” الذي تُكشف خلاله باقي الجوائز تباعاً في مجالات الفيزياء، الكيمياء، الأدب، السلام، والاقتصاد. يجلس الصحفيون في قاعة نوبل بمعهد كارولينسكا، ينتظرون كلمة رئيس اللجنة النوبلية. وحين يُنطق الاسم، تبدأ وكالات الأنباء العالمية بنقل الخبر إلى ملايين الشاشات في مختلف القارات.
لكن المجد الحقيقي لا يكتمل إلا في العاشر من ديسمبر، ذكرى وفاة ألفرد نوبل، حين يُقام حفل نوبل الملكي في قاعة ستوكهولم للحفلات الموسيقية وبحضور العائلة الملكية السويدية وكبار الشخصيات العلمية والثقافية، يتسلّم الفائز ميدالية نوبل الذهبية التي تحمل صورة نوبل، وشهادة تقدير مكتوبة بخط يدوي فني، وجائزة مالية تبلغ حوالي 11 مليون كرونة سويدية عام 2025.
ومع أن القيمة المادية للجائزة كبيرة، فإن رمزيتها تفوق كل الأرقام. فهي شهادة من الإنسانية إلى أبنائها المبدعين، تقول لهم: لقد غيّرتم العالم نحو الأفضل. لا شيء يضاهي تلك اللحظة حين يقف العالم الفائز، محاطًا بعائلته وزملائه، ليُلقي كلمته القصيرة المفعمة بالامتنان. في تلك اللحظة، لا يتحدث عن نفسه، بل عن الفريق، والبحث، والعمر الذي انقضى في مختبرٍ بين شكٍّ وتجربةٍ ويقينٍ صغير.
تُعتبر جوائز نوبل اليوم مرجعًا ثقافيًا عالميًا، تتجاوز قيمتها العلمية إلى رمزية أخلاقية عميقة؛ إذ تمثل التقاء الفكر بالضمير، والعلم بالمسؤولية، والطموح الإنساني بالحكمة. ولذلك، فإن كل إعلانٍ جديد ليس مجرد تكريمٍ لماضٍ علمي، بل وعدٌ بمستقبلٍ أكثر وعيًا وعدلاً للبشرية جمعاء.
كيف تصنع اكتشافات قليلة مستقبل الإنسانية
من بين كل فروع جائزة نوبل، تبقى جائزة الطب أو الفسيولوجيا الأقرب إلى قلب الإنسان، لأنها لا تُكرّم مجرّد فكرة علمية، بل تخلّد إنجازًا مسّ جوهر الحياة ذاتها. فالفيزياء تفسّر الكون، والكيمياء تفكّك المادة، أما الطب فيعيد صياغة مصير البشر. وربما لهذا السبب، كانت جائزة نوبل في الطب دائمًا أكثر الجوائز التي غيّرت وجه التاريخ العملي والإنساني معًا.
تُمنح الجائزة لمن “قدّم أعظم فائدة للبشرية” في فهم وظائف الجسم أو معالجة أمراضه. ولذلك، لم تكن يومًا جائزة نظرية، بل امتدادًا لرسالة ألفرد نوبل نفسه، الذي أراد أن تُكافأ الاكتشافات التي تُنقذ الحياة وتُخفف الألم وتمنح الأمل.
في كل عقد، تقف الجائزة شاهدة على تحوّل عميق في فهمنا للطبيعة البيولوجية للإنسان. حين مُنحت عام 1945 للعلماء الذين اكتشفوا البنسلين، تغيّر مسار الطب من مواجهة العجز إلى صناعة العلاج. وحين نالها واطسون وكريك عام 1962 لاكتشافهم بنية الحمض النووي، بدأت الثورة الوراثية التي مهّدت للطب الشخصي والعلاجات الجينية. وفي العقد الأخير، حين فاز يوشينوري أوسومي عن أبحاثه في الالتهام الذاتي، اتسعت آفاقنا حول الشيخوخة والأمراض التنكّسية.
لكن وراء كل إنجاز من هذا النوع، سنوات من العزلة والتجريب والخطأ، وعشرات المحاولات التي لم تُثمر. لذلك، فإن جائزة نوبل في الطب لا تُكافئ فقط النجاح العلمي، بل الصبر الإنساني الذي يقف خلفه. هي تكريمٌ لفكرة أن الإصرار على الفهم أسمى من مجرّد السعي إلى الشهرة.
وما يجعل هذه الجائزة مختلفة عن غيرها هو أثرها الفوري في السياسات الصحية العالمية. فحين يسلّط الإعلان عنها الضوء على مجال محدد، تتحرك المراكز البحثية والحكومات والتمويلات نحو هذا الاتجاه، كما لو أن الجائزة ترسم خارطة طريق للطب الحديث. لقد كانت نوبل في كثير من الأحيان بوصلة الإنسانية في أزماتها الصحية الكبرى، من فهم الفيروسات، إلى تطوير اللقاحات، إلى فتح أبواب علم المناعة والعلاج بالخلايا الجذعية.
ومع مرور الزمن، تحوّلت جائزة نوبل في الطب من وسامٍ شخصي إلى رسالة أخلاقية تؤكد أن المعرفة ليست امتيازًا، بل مسؤولية. فكل اكتشافٍ طبي يحمل في طياته وعدًا بحياةٍ أطول، وألمٍ أقل، ومستقبلٍ أكثر رحمة.
ومن ثمّ، فإن كل فائز في هذا المجال لا يُعتبر فقط عالِمًا متميّزًا، بل امتدادًا لضمير البشرية حين تقرر أن تواجه ضعفها بالعلم، وأن تبني في مختبر صغير ما يُعيد الأمل لملايين الأرواح حول العالم.
الخاتمة
منذ أكثر من قرن، ما زالت جائزة نوبل تذكّر العالم بأن التقدّم الحقيقي ليس في تراكم الاكتشافات، بل في توجيهها نحو خدمة الإنسان. لقد أراد ألفرد نوبل أن تكون جوائزه مرآةً لأفضل ما فينا، لا لأذكى ما فينا فقط؛ ولذلك، ظلّت نوبل رمزًا للعلم حين يتجرد من الأهواء، وللعبقرية حين تُسخَّر للخير العام.
وفي كل عام، حين تُعلَن الأسماء الجديدة، ندرك أن المعرفة ما زالت قادرة على أن تُلهمنا كما كانت تفعل منذ أن كتب نوبل وصيته الأخيرة. فبين كل تجربةٍ علميةٍ وإنجازٍ بشريّ، ثمة خيطٌ خفيّ من الإيمان بأن الإنسان يستطيع أن يجعل من العلم طريقًا للرحمة، ومن الفهم سلاحًا ضد الجهل والمرض والموت.
إن جائزة نوبل ليست نهاية إنجاز، بل بداية التزام. التزامٌ بأن تبقى الإنسانية وفيةً لفكرتها الكبرى: أن العقل حين يرتفع بالضمير، يصبح العلم رسالةً لا تُمنح لشخص، بل للبشرية جمعاء.