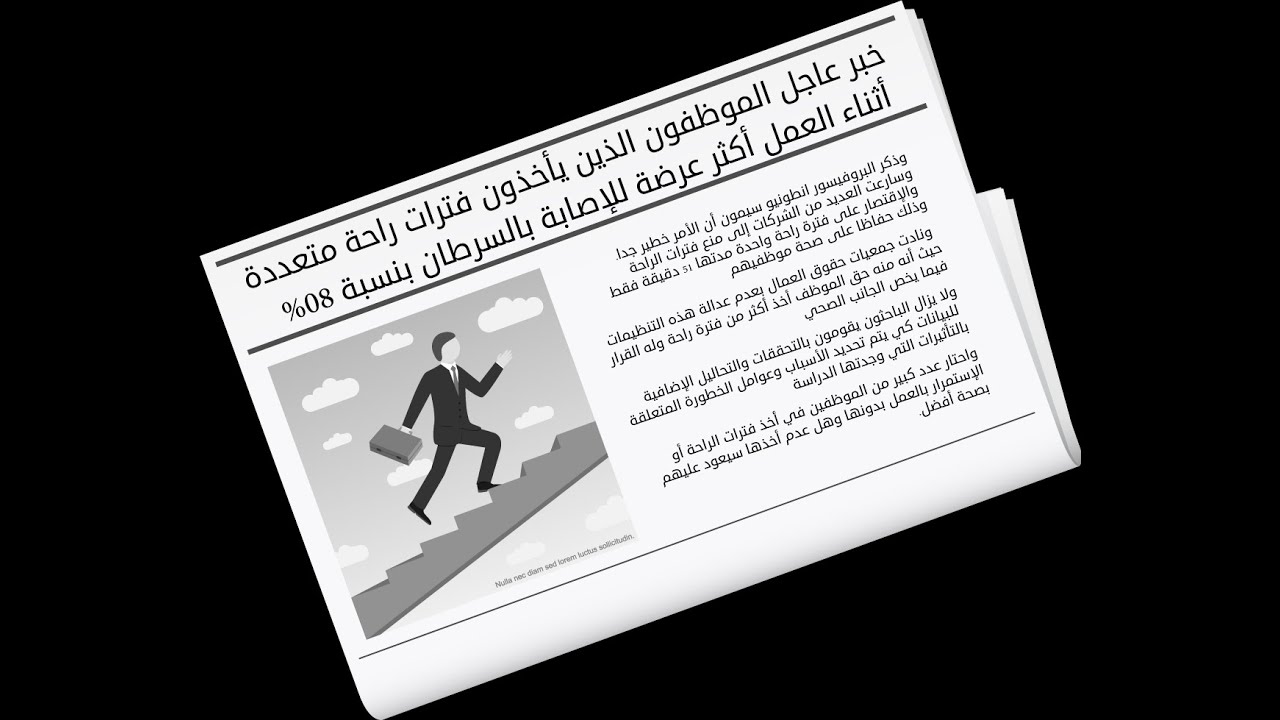المركزية مقابل التفويض: أيهما يصنع الفرق في بيئات العمل الناضجة؟
عندما يتحول دور القائد من السيطرة إلى التمكين، تتغير ملامح بيئة العمل وتتحرر الفرق من قيود المركزية، ليولد الابتكار وتزدهر روح المبادرة. استكشف كيف يعيد التفويض رسم العلاقة بين القائد وفريقه ويصنع ثقافة ثقة ونمو.

هل تُقاس قوة القائد بما يحتفظ به من صلاحيات، أم بما يجرؤ على منحه؟ وهل تُبنى الفرق الفاعلة على مركزية القرار، أم على توزيع الثقة؟ حين يصبح السؤال عن السلطة سؤالًا عن النضج، لا عن السيطرة، تتغير قواعد القيادة، ويُعاد رسم العلاقة بين الفرد والمؤسسة، وبين الرؤية والتنفيذ.
التفويض كأداة لتمكين الفرق وتعزيز الثقة
التفويض، في جوهره، ليس مجرد نقل للمهام، بل هو إعادة هندسة للثقة داخل المؤسسة. إنه انتقال من نمط التحكم إلى نمط التمكين، ومن احتكار القرار إلى توزيع المسؤولية. حين يُمارس التفويض بوعي، يتحول الفريق من منفذ إلى شريك، ومن تابع إلى مساهم في صياغة النتائج. وهو لا يُقاس بكمّ المهام المنقولة، بل بنوعية الصلاحيات الممنوحة، وبالقدرة على خلق بيئة تسمح بالتجربة، والتعلم، واتخاذ القرار.
وقد عبّر ستيفن كوفي عن هذا المعنى بقوله: "التفويض الفعال لا يعني فقط نقل المهام، بل هو تمكين الآخرين من اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، مما يخلق بيئة من النمو والثقة." وهذا ما يجعل التفويض في الفرق عالية الأداء ضرورة بنيوية، لا مجرد خيار تنظيمي. فهذه الفرق، بحكم خبرتها وكفاءتها، لا تحتاج إلى تعليمات تفصيلية، بل إلى إطار مرن يُحتضن فيه الإبداع، ويُصان فيه الاستقلال المهني.
المركزية وأثرها على الابتكار والاستقلالية
في المقابل، تُمثل المركزية نمطًا إداريًا يُركّز السلطة في يد القائد أو الإدارة العليا. وهي، وإن كانت فعالة في بعض السياقات الحرجة كإدارة الأزمات أو ضبط الهوية المؤسسية، إلا أنها تُصبح عبئًا حين تُمارس في بيئات ناضجة أو فرق ذاتية التنظيم. وقد حذّر بيتر دراكر من هذا النمط بقوله: "المركزية تُضعف الابتكار، لأنها تقتل المبادرة وتُحوّل الموظفين إلى منفذين لا مفكرين."
المركزية، حين تُمارس بلا وعي، تُنتج ثقافة من الاتكالية، وتُضعف روح المبادرة، وتُحوّل القائد إلى مراقب مهووس بالتفاصيل، بدلًا من أن يكون مُلهِمًا للرؤية. وحين تُصبح نمطًا دائمًا، فإنها تُنتج بيئة عمل متوترة، تُضعف الولاء، وتُعيق النمو، وتُحوّل القائد إلى عنق زجاجة يُبطئ كل شيء.
وقد أكدت دراسة أكاديمية بعنوان "تفويض الصلاحيات والمركزية في الشركات" أن التفويض يمثل ركيزة أساسية للتمكين والنمو، بينما المركزية المفرطة تُعد من أبرز معوقات الابتكار المؤسسي. وتُظهر نتائج الدراسة أن المؤسسات التي تُعيد توزيع السلطة بوعي، وتُمنح فيها الفرق مساحة لاتخاذ القرار، تُحقق مستويات أعلى من الأداء والاستقلالية المهنية، مقارنةً بتلك التي تُبقي القرار محصورًا في قمة الهرم الإداري.
أما التفويض، فهو يُعزز الكفاءة، ويُكرّس ثقافة الاحترام، ويُعيد تعريف العلاقة بين القائد والفريق. إنه لا يُلغي دور القيادة، بل يُعيد تشكيله. فالقائد، في ظل التفويض، لا يراقب التفاصيل، بل يرسم الاتجاه، ويحدد الإطار، ويمنح الآخرين الثقة ليبدعوا داخله.
إعادة تعريف السلطة داخل الفرق لا تنبع من تعديل الهيكل الإداري فحسب، بل من تحول في فلسفة القيادة. فالقائد الذي يرى في التفويض ضعفًا، يُحوّل فريقه إلى تابعين. أما القائد الذي يرى فيه تمكينًا، فإنه يُحوّل فريقه إلى شركاء. وبين هذين النموذجين، تتحدد قدرة المؤسسة على النمو، والاستدامة، والتأثير.
وحين تُمنح الصلاحيات بوعي، وتُوزع المسؤوليات بثقة، لا يعود السؤال عن من يملك القرار، بل عن من يصنع الأثر. فهل يمكن للفرق أن تظل جامدة حين تُفتح أمامها أبواب المبادرة؟ وهل تبقى المؤسسات أسيرة التكرار حين تُحرر طاقاتها من مركزية القرار؟ لعلّ أعظم ما في التفويض ليس ما يُمنح، بل ما يُكتشف بعد المنح.