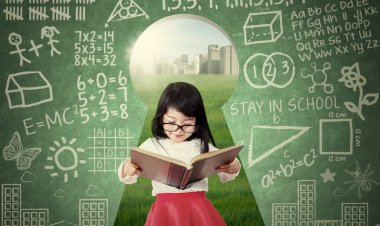آرثر شوبنهاور: دروس من فلسفة التشاؤم في مواجهة الحياة
رؤية مختلفة للتشاؤم، تكشف كيف يمكن أن يكون بوابة نحو التعاطف والتحفيز الداخلي. مقال فلسفي يضيء الجانب الإيجابي من أعماق الألم، ويلهمنا لفهم الذات وتقدير الفن.

يُلقَّب آرثر شوبنهاور غالبًا بـ"فيلسوف التشاؤم"، لأنه يرى أن الوجود يولد من رحم المعاناة، وأن السعادة ليست غاية نسعى إليها، بل تختزل في لحظاتٍ عابرة من الراحة المؤقتة من الألم. لكن التشاؤم، في فلسفة شوبنهاور، لا يُعدّ نقيصةً في الرؤية؛ بل يُشكّل منظورًا يساعدنا على تنمية التعاطف مع كل الكائنات التي تتقاسم معنا عبء الحياة.
ينهمك المتشائمون كثيرًا في الحديث عن المعاناة. يتأملون خواء الوجود، ويركّزون على رتابة الأيام، ويلاحقون العبارات التحفيزية بسخرية لاذعة، وكأنهم يخوضون صراعًا دائمًا مع أي بارقة أمل. ولعلّ المرء يلتقي في حياته بمتشائمٍ أو اثنين، بل إن في داخل كلٍّ منّا ظلًّا خافتًا لهذا الصوت الذي يُشكّك أحيانًا في كل شيء.
ومع ذلك، حين ننظر إلى خارطة الفكر البشري، لا نجد أحدًا يجسّد فلسفة التشاؤم بأبعادها الوجودية والنفسية كما فعل آرثر شوبنهاور. والمفارقة أن هذا اللون القاتم من التفكير لا يقود دائمًا إلى الانكفاء أو اليأس، بل يمنحنا أدوات لفهم الذات، والتعاطف مع الآخرين، وتقدير الفن بوصفه مهربًا مؤقتًا من سطوة الألم.
فيما يلي، ثلاث دروس فلسفية يمنحنا إياها التشاؤم حين نتأمله بعين شوبنهاور:
التشاؤم سبيلٌ إلى التعاطف
انطلق شوبنهاور في تأملاته من نفي قاطع لفكرة السعادة، ورأى أنها لا تتجلى إلا في لحظات متفرقة من الراحة المؤقت من الألم. حصر شوبنهاور ما يمكن للإنسان بلوغه في مساحة ضيقة لا تتجاوز حدود الإفلات من معاناة مفرطة أو رغبات لم تُشبع. كتب عبارته الأشهر: "الحياة تتأرجح، كالبندول، بين الألم والملل." لم يأتِ هذا القول اعتباطًا، ولم تُنسب إليه صفة "فيلسوف التشاؤم" على سبيل المبالغة؛ بل خرجت من صلب رؤيته للوجود.
مع ذلك، لم يتوقف شوبنهاور عند هذا الحد. بل أدرك، بفطنته الفلسفية، أن تصوير الحياة كجحيمٍ أرضي لا يُطاق لن يمنحه جمهورًا وفيًا. كان يعلم أن المؤلفات المتشائمة نادرًا ما تلقى رواجًا، وأنها لا تدرّ على مؤلفها إلا القليل. فقد سبقه إلى التشاؤم مفكرون كثر، نطقوا بمرارة الوجود، لكن تلاشى أثرهم، ولم يدم لهم حضور في وجدان القرّاء.
يصرّح بايذر وودز، أستاذ الفلسفة في جامعة وورويك، قائلًا: «المحبّة تكتسب أهمية بالغة. فلو لم يؤمن شوبنهاور بشكلٍ من أشكالها، لصعُب تحمّل فلسفته إلى حدّ بعيد. قد تبدو فلسفة التشاؤم قاسية، متجهمة، وربما كارهة للنوع البشري... لكنها قادرة على أن تسير جنبًا إلى جنب مع التعاطف.» يتلخّص جوهر هذه النظرة في أن إبداء الرحمة تجاه إنسان ما هو إقرارٌ بحقيقة ألمه، وأخذٌ لمعاناته على محمل الجد، واستجابة له بمحبة ورحمة.
يرى شوبنهاور أن التعاطف يشكّل أصل الأخلاق ومنطلقها. ولا يستطيع الإنسان أن يكون رحيمًا تجاه غيره ما لم يُدرك حقيقتين جوهريتين: أولاهما، أن الجميع يعاني بلا استثناء. وثانيتهما، أن معاناة الآخرين حقيقية وجدّية، ولا يجوز التهوين منها. فقط حين نتقبّل هاتين الحقيقتين — على سوداويتهما — نستطيع أن نقترب من الآخر، ونمدّ له يدًا تحمل شيئًا من الرحمة والعزاء.
التشاؤم سبيل التعاطف تجاه كل الكائنات الحية
لا يُفرّق التشاؤم بين كائنٍ وآخر؛ فالمعاناة، في نظر شوبنهاور، لا تعترف بحدود ولا جنسيات ولا أنواع. فالمعاناة هي الوجه الحقيقي للحياة في منظورة— ليس عند الإنسان وحده، بل في كلّ كائن حيّ نابض بالشعور. وكما يقول بايذر وودز: «تجري المعاناة مجرى الدم عند كل الكائنات الحية في نظر شوبنهاور. ويستحقّ أن نقابل كلّ من يعاني بشئٍ من التعاطف.»
شعر شوبنهاور باشمئزازٍ شديد نحو أي شكل من أشكال القسوة تجاه الحيوان، حتى أنه استمد أوائل روّاد حركة الرفق بالحيوان إلهامهم منه مباشرة. فإذا كنّا نُقرّ بمعاناة كلّ الكائنات الحية، وأن الرحمة في وجه هذه المعاناة منبع الأخلاق، فلا مبرّر — أخلاقيًا ولا إنسانيًا — للتوقف عن إظهار التعاطف في أي موضع لا تزال فيه المعاناة قائمةً.
لا يستند هذا الطرح إلى حجّة بيولوجية، ولا يعتمد على خرائط الأعصاب في جسد الأخطبوط، أو على نقاشات معقّدة حول درجات الوعى في المملكة الحيوانية. بل يقوم على أساس فلسفي بحت، يرى أن المعاناة تمثل التجلي المباشر لما سمّاه شوبنهاور "الإرادة" — تلك القوة العمياء، التي لا تعرف الكلل، والتي تدفع كل كائن حيّ إلى الرغبة، والسعي نحوها، ثم الوقوع في قبضة الألم.
في الفن تجد لحظات الخلاص
إذا كان التشاؤم يدفعنا إلى إظهار التعاطف — مع أنفسنا، ومع من حولنا، ومع سائر الكائنات الحيّة — فكيف يخفف التعاطف من وطأة المعاناة، ولو لوهلة عابرة، لا تكاد تُقاس في ميزان الوجود؟
يتجلّى جانب كبير من التخفيف من المعاناة في حصول المرء على ما يشتهي. فتخفف وطأة العطش بالارتواء. ويجد المرء فُكاكًا من الوحدة في مجالسة من يؤنسه. غير أن شوبنهاور — وقد تأثّر على الأرجح بالفلسفات الشرقية المتداولة آنذاك، لا سيّما الهندية منها — رأى في هذا كله لعبةً عبثية. فدورة الرغبة والإشباع لا تنقطع، وما تمنحه من راحة ليست سوى هُدنة مؤقتة، لا ترقى إلى جوهرٍ يعصم الروح من الألم.
رأى شوبنهاور — الذي لم يكن بوذيًا — أن السبيل الوحيد لتخفيف معاناة الحياة بصورة مجزية يكمن في الانغماس التام في التجربة الجمالية، وهي حالة الاندماج الكامل في لحظة جمالية حسّية أو معنوية تُغيّب الوعي بالذات، وأن تغوص في عالم أدبي يمحو الحدود بينك وبين النص، أو أن تنثر الألوان على لوحة في لحظة تجلٍ خالية من الأنا.
يقول بايذر وودز: «نال شوبنهاور تقديرًا كبيرًا في الأوساط الفنية بعد وفاته، لا سيّما لأنه رأى في التجربة الجمالية — سواء في الفن أو في جمال الطبيعة — شكلًا مؤقتًا من التحرر من إرادة الحياة.»
لقد اعتبر الفن واحةً من السكون والطمأنينة، ووجد فيها ملاذًا يمكن اللجوء إليه. ورغم أن الفنون تظل، بطبيعتها، حكرًا على فئات بعينها، فإنها تظلّ أقل انغلاقًا من الانقطاع عن العالم واعتزال الحياة.
الحياة هي المعاناة ذاتها، ولا شكّ أن في هذا القول نبرةً عميقة من التشاؤم. لكن التشاؤم، في جوهره، لا يشلّ الإرادة، بل يحفّزها. إنه أحد أعظم البواعث على الفعل. ترافق المعاناة كلّ الكائنات الحيّة، وجميعها تسعى، بغريزتها، إلى التخفف منها. ولا يتحقّق هذا التخفف إلا عبر ثلاثة سُبل: إظهار التعاطف مع البشر، وتجاه سائر الكائنات الحية، والانغماس في جمال الفن بما يتيحه من مهربٍ مؤقّت من سطوة الوجود.