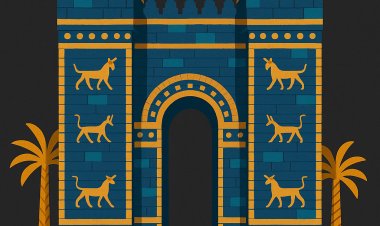التجويع في تاريخ الحروب الحديثة: سلاح خفي أشد فتكًا من الرصاص؟
مقال تحليلي يتناول استخدام التجويع كسلاح ممنهج في الحروب، من غزة إلى لينينغراد وبيافرا، مرورًا بالإبادة البطيئة للسكان الأصليين في أمريكا، وصولًا إلى تقنين التجويع في شيفرة ليبر، ورصده كجريمة حرب في القانون الدولي.

"عندما لا يموت الطفل من قصف أو من رصاصة بل لأنه جوعانٌ فحسب فهذه ليست مأساة بل نهاية العالم"
كثيرًا ما يسير الجوع والحرب جنبًا إلى جنب. فقد يكون التجويع نتيجة مباشرة لأعمال العنف، كأن تدور المعارك فوق الحقول المزروعة، أو يكون نهجًا مقصودًا ضمن استراتيجية عسكرية مُحكمة.
وهذا الاحتمال الأخير يُلقي بظلاله الثقيلة على مجريات الصراع الكارثي في غزة. فدولة الاحتلال، بدايةً، قطعت كل أشكال المساعدات، ثم سمحت بدخول المعونات الغذائية، ولكن على نحوٍ شحيح لا يسدّ رمقًا، حتى إن الأمم المتحدة حذّرت من مجاعة وشيكة تُهدّد معظم السكان وبل وقد اجتاحتهم اليوم.
وقد أثارت هذه القيود على الغذاء موجة انتقادات دولية لدولة الاحتلال، وسط اتهامات بأنها تمارس شكلًا من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، ردًّا على هجوم حركة حماس المباغت في السابع من أكتوبر. بل إن ثمة من يرى في هذه الإجراءات تجويعًا متعمّدًا يُستخدم كسلاح حرب ضمن استراتيجية عسكرية.
وإن صحّ ذلك وهذا ما يقوله الواقع، فإن دولة الاحتلال ليست إلا حلقة جديدة في سلسلة طويلة من استخدام التجويع كأداة في ساحات الحروب ضد سكان الأرض الأصليين.
حين يُصبح التجويع سلاحًا لتقويض الشعوب
ثمّة سببين جوهريين يقفان خلف لجوء الجيوشٍ إلى سلاح التجويع. الأول يتجسّد في إنزال العقوبة بالخصم أثناء النزاع، وكأنّ حرمانه من القوت يُشكّل امتدادًا للضربات العسكرية المباشرة.
أما السبب الثاني، فينتمي إلى حقل الاستراتيجيات الحربية الباردة؛ إذ يُستخدم التجويع كوسيلة لإضعاف عزيمة العدو، لا عبر تجويع جنوده فحسب، بل من خلال إنهاك مجتمعه بأسره، مدنيين وعائلات، ببطءٍ يُفتّت الإرادة ويكسر شوكة الصمود.
وفي حالات كثيرة، كان الجوع القسري عاملًا حاسمًا في دفع العدو إلى الرضوخ. ومع أنّ السجلّ التاريخي يُظهر نتائج متفاوتة لهذا التكتيك، فإنّ ما لا جدال فيه هو الأثر المروّع الذي تخلّفه المجاعة المتعمّدة في نفوس من يقعون فريستها.
- إنّ توظيف التجويع كسلاح حرب ليس بدعة حديثة، بل يعود إلى قرونٍ موغلةٍ في القِدم، وقد خلّد التاريخ محطّات دامغة لهذا النهج الوحشي. لعلّ من أبرزها ما شهده العالم القديم إبّان الحرب البونيقية الثالثة (149–146 ق.م)، حين فرضت روما حصارًا خانقًا على قرطاجنة، غريمتها اللدودة التي نافستها على السيادة لأكثر من قرن.
كان الحصار محكمًا إلى حدّ خنق المدينة، وقاد إلى مجاعة طاحنة حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين، قبل أن تسقط قرطاج في قبضة روما، وتُباد عن بكرة أبيها.
التجويع كسلاح استعماري من التاريخ الأمريكي ضد السكان الأصليين
من اللافت أنّ أحد الأمثلة التاريخية الموازية لما يشهده الصراع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة فلسطينين بعاصمتها غزة لا يأتي من الشرق الأوسط، بل من قلب القارة الأمريكية الشمالية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، حيث مارست قوى استعمارية سياسات تجويع مُمنهجة ضد السكان الأصليين، في إطار حملات حربية هدفها الإخضاع والإبادة الجماعية.
تُشير الأدلة إلى أنّ شعوب كونفدرالية الإيروكوا — وهي رابطة تضمّ عدة أمم من السكان الأصليين في أمريكا الشمالية — حملت في ذاكرتها اللغوية أثرًا بالغًا لهذه الحقبة العنيفة؛ إذ ما تزال تُطلق على رئيس الولايات المتحدة حتى اليوم اسم كونوتوكاريوس، أي "مُدمّر البلدات"، وهي تسمية أُلصقت بدايةً بالجنرال جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، وذلك بسبب الحملة العسكرية الشرسة التي شنّها جيشه على قرى الإيروكوا.
ففي إطار انتقامي ردًا على هجمات شنّها بعض أفراد الكونفدرالية المتحالفين مع البريطانيين ضد مستوطنات أمريكية، أمر واشنطن بتنفيذ سياسة "التدمير الكامل والممنهج" لعشرات قرى السكان الأصليين في ما يُعرف حاليًا بولاية نيويورك.
امتدت الحملة على مدى أربعة أشهر، وأسفرت عن محو أكثر من أربعين قرية عن الوجود، بما فيها من محاصيل ومخازن غذاء، ما أدى إلى إنهاك البنية العسكرية لشعوب الإيروكوا، وإلى نزوح واسع النطاق، وموت المئات خلال شتاء قاسٍ أعقب الحملة.
لم تقتصر هذه الاستراتيجية على شرق أمريكا فحسب، بل شقّت طريقها نحو الغرب مع توسّع الولايات المتحدة، حيث قوبلت موجات الاستيطان بمقاومة شرسة من قبل شعوب أصليّة رفضت الخضوع.
ولتحطيم هذه الروح المقاومة، تحوّلت المؤن الغذائية إلى هدف مركزي. ففي ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، تمّ عمدًا القضاء على قطعان البيسون (الجاموس الأمريكي)، التي كانت تمثّل المورد الغذائي الرئيسي لعديد من الشعوب الأصلية في الغرب، وعلى رأسها شعب السيو.
أما كندا، الجارة الشمالية للولايات المتحدة، فقد اقتفت الأثر ذاته؛ إذ لجأت الحكومة الكندية في ثمانينيات القرن التاسع عشر إلى حرمان المجتمعات الأصلية من الحصص الغذائية الموعودة، بهدف إجبارهم على القبول بأراضٍ فُرضت عليهم بموجب المعاهدات.
حملات التجويع الكبرى في العصر الحديث
خلال القرن الماضي، لجأت دولٌ عدّة إلى استخدام التجويع سلاحًا حربيًّا في ساحات النزاع، تاركةً خلفها مآسيَ إنسانية لا تُنسى.
ومن أكثر هذه الحملات فتكًا ما شهدته الحرب العالمية الثانية، حين غزت قوات ألمانيا النازية الاتحاد السوفييتي وفرضت حصارًا محكمًا على مدينة لينينغراد — سانت بطرسبرغ حاليًا — في محاولة لدفعها إلى الاستسلام.
فمنذ سبتمبر عام 1941 وحتى يناير 1944، أي طيلة 28 شهرًا، قُطعت الإمدادات الغذائية عن المدينة بشكل شبه كامل.
ورغم أن سكان لينينغراد لم يرفعوا الراية البيضاء، إلا أنّهم دفعوا ثمنًا باهظًا؛ إذ قضى نحو 22% من سكان المدينة، الذين بلغ عددهم آنذاك قرابة ثلاثة ملايين نسمة، بسبب الجوع وما ارتبط به من أمراض ومضاعفات.
وتُظهر دراسات طبية أُجريت على مدى عقود لاحقة أنّ الرجال الذين عاشوا فترة الحصار كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض مزمنة مقارنةً بنظرائهم الروس الذين لم يتعرّضوا لتجويع مماثل.
وفي مثال مروّع آخر، شهدت نيجيريا بين عامي 1967 و1970 حملة تجويع ممنهجة خلال الحرب الأهلية التي اندلعت إثر إعلان مجموعة الإيبو العرقية استقلالها تحت اسم "بيافرا".
وعلى مدى ثلاث سنوات، قُوضت الحكومة النيجيرية الدولة الوليدة بحصار اقتصادي قاسٍ، شمل منع الغذاء والدواء، ما أسفر عن كارثة إنسانية أودت بحياة ما بين نصف مليون إلى مليونَين من المدنيين، معظمهم من الأطفال.
وفي العقود الأخيرة، لم يتوقّف استخدام التجويع كسلاح حرب، بل تجلّى بفظاعة في عدد من النزاعات الإقليمية:
في الحرب الأهلية السورية التي اندلعت عام 2011، استخدم النظام السوري التجويع كسلاح حصار، مُستهدفًا الأسواق ومصادر التموين، مع منع وصول المساعدات إلى مناطق بعينها.
وفي اليمن، خلال الحرب التي بدأت في الفترة نفسها، فُرضت قيود مشددة على الموانئ الحيوية، ما فاقم أزمة الجوع وتسبب في وفاة الآلاف.
أما في جنوب السودان، ومنذ عام 2013، فقد شهدت البلاد حربًا أهلية اتُّخذ فيها الطعام هدفًا مباشرًا، عبر هجمات ممنهجة على مراكز تخزين الغذاء وقوافل الإمداد، الأمر الذي أودى بحياة مئات الآلاف.
شيفرة ليبر: حين شرّعت الحرب الأمريكية التجويع كسلاح مشروع
ليس من المُستغرب أن يبقى استخدام التجويع المتعمد سلاحًا مثيرًا للجدل، رغم رسوخه عبر القرون في صفحات الحروب.
ففي ستينيات القرن التاسع عشر، وخلال الحرب الأهلية الأمريكية، حاولت الولايات الشمالية — التي خرجت لاحقًا منتصرة — تقنين التجويع كتكتيك عسكري مشروع، ضمن مسعى لترسيخ "قواعد أخلاقية" للحرب.
ففي أبريل عام 1863، أصدرت إدارة الرئيس أبراهام لينكولن ما عُرف لاحقًا باسم شيفرة ليبر، وهي وثيقة قانونية صاغها الأكاديمي البروسي الأمريكي فرانسيس ليبر، تضمّنت قائمة مفصّلة بالقواعد التي اعتُبرت آنذاك "مشروعة" في ساحة القتال.
في المادة 17 من هذه الشيفرة، أتى النص صريحًا في تقنين سلاح الجوع:
"لا تُخاض الحرب بالسلاح وحده. ومن الجائز تجويع العدو — سواء كان مسلّحًا أو غير مسلّح — إن كان ذلك يُفضي إلى إخضاعه بصورة أسرع."
غير أن شهد القرن العشرين جهودًا متكررةً لإدراج التجويع القسري ضمن قائمة جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
فقد نصّت لجنة المسؤولية الدولية، التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، صراحةً على أنّ التجويع المتعمد يُعدّ انتهاكًا للقانون، ويستوجب الملاحقة القضائية.
وفي تطوّر أكثر وضوحًا، جاء نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2002 ليُجرّم صراحةً:
"تجويع المدنيين عمدًا بوصفه وسيلة من وسائل الحرب، عبر حرمانهم من المواد الأساسية لبقائهم، بما في ذلك إعاقة وصول المساعدات الإنسانية عمدًا، كما نصّت اتفاقيات جنيف".
ومع ذلك، فإن هذا السلاح القاتل لا يزال يُستخدم حتى يومنا هذا، جزئيًّا بسبب تداخله القانوني؛ إذ تسمح بعض الدول بفرض الحصار ومنع الإمدادات الغذائية ما دامت تهدف إلى تحقيق غايات عسكرية، لا إلى تجويع المدنيين صراحةً.
لكن الفاصل بين الأمرين يبقى هشًّا وغائمًا — تاريخيًا وحاضرًا — وغالبًا ما يُتجاهل هذا الخط الفاصل تمامًا في خضمّ المعارك.
ولا يبدو، للأسف، أن المستقبل سيتبرّأ من هذا الإرث الدموي، طالما بقيت شراسة الإنسان نحو الإنسان.