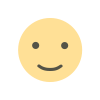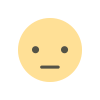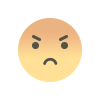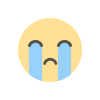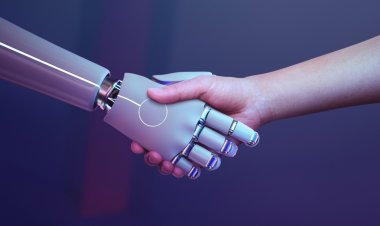خرافة السعرات الحرارية: لماذا يفشل الملايين رغم التزامهم
هل السعرات الحرارية وحدها هي مفتاح فقدان الوزن؟ يكشف هذا المقال العلمي المثير كيف تخدعنا الأرقام، ويأخذك في رحلة عبر علم الوراثة، الأيض، والبيئة الغذائية لفهم أعمق للسمنة. ستتعرف على أسرار لا تروى في الحميات التقليدية، وتكتشف لماذا يحتاج الجسم لأكثر من مجرد معادلة رياضية لخسارة الوزن.

مقدمة
لطالما كان مبدأ "السعرات الحرارية الداخلة مقابل السعرات الخارجة" حجر الزاوية في السياسات الغذائية والنصائح الصحية المتعلقة بفقدان الوزن. ومع ذلك، تشير الأدلة العلمية المتراكمة إلى أن هذه المعادلة الميكانيكية تتجاهل التفاعلات المعقدة بين الغذاء، الأيض، الوراثة، والسلوك البشري. في كتابة Why Calories Don’t Count، يقدم الدكتور Giles Yeo، الباحث في علم الوراثة والدماغ بجامعة كامبريدج، طرحًا علميًا يستند إلى البيولوجيا العصبية والوراثة الغذائية لإثبات أن السعرات الحرارية ليست مقياسًا دقيقًا أو عادلًا لحساب التغذية أو التحكم بالوزن.
1. الأصل المفاهيمي للسعرات الحرارية ومحدوديته في العلوم الحيوية
تُعرَّف السعرة الحرارية بأنها كمية الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة غرام واحد من الماء بمقدار درجة مئوية واحدة. هذه الطريقة الفيزيائية الحسابية، التي تُقاس باستخدام (Bomb Calorimeter)، تُستخدم في تحديد محتوى الطاقة في الأغذية. لكن هذا القياس لا يعكس ما يحدث فعليًا داخل الجسم البشري، الذي يعتمد على الإنزيمات، والهرمونات، والتفاعلات البيولوجية المعقدة لهضم، وامتصاص، وتخزين العناصر الغذائية. في الواقع، تختلف كفاءة الجسم في استخلاص الطاقة من الغذاء حسب نوعه. فمثلاً، تشير الدراسات إلى أن المكسرات تحتوي على سعرات حرارية أقل مما هو مذكور على الملصقات الغذائية بسبب الامتصاص غير الكامل للألياف (Novotny et al., 2012).
2. ليست كل السعرات متساوية: التأثير الأيضي والهرموني
يُظهر العلم أن السعرات الحرارية المستمدة من أنواع مختلفة من المغذيات (بروتين، كربوهيدرات، دهون) تُعامل بشكل مختلف من قبل الجسم:
-
البروتين يتطلب طاقة أكبر لهضمه (حوالي 20-30% من طاقته تُستهلك أثناء الهضم)، ويؤدي إلى إفراز هرمونات الشبع مثل الـPYY والـGLP-1.
-
الكربوهيدرات المكررة تُسبب ارتفاعًا حادًا في الإنسولين يليها انخفاض سريع في السكر، ما يعزز الشعور بالجوع.
-
الدهون تختلف تأثيراتها حسب نوعها (دهون مشبعة مقابل غير مشبعة)، وتُهضم بشكل أبطأ، ما يؤدي إلى إحساس أطول بالشبع.
وبالتالي، فإن الاعتماد على السعرات فقط يتجاهل هذه الاختلافات الجوهرية في التأثير الأيضي لكل نوع غذائي.
3. التأثير الوراثي والبيولوجي على الشهية والوزن
تشير الأدلة العلمية الحديثة إلى أن العوامل الوراثية والبيولوجية تلعب دورًا جوهريًا في تحديد قابلية الفرد لاكتساب الوزن أو فقدانه، وذلك خلافًا للتصور الشائع الذي يربط السمنة فقط بالإفراط في تناول الطعام أو قلة النشاط البدني. فالشهية، ومعدل الأيض، وتوزيع الدهون في الجسم، وحتى استجابة الفرد للطعام، جميعها تخضع لتنظيم معقد تشارك فيه عدة مسارات جينية وهرمونية.
أحد أبرز الجينات المرتبطة بتنظيم الشهية هو جين MC4R، الذي يؤثر على إشارات الشبع في الدماغ. وقد أظهرت الدراسات أن الطفرات في هذا الجين ترتبط بزيادة الرغبة في تناول الطعام وتراجع الإحساس بالشبع، مما يرفع من خطر الإصابة بالسمنة، خاصة لدى الأطفال. كذلك، فإن جين FTO، وهو من أكثر الجينات ارتباطًا بالسمنة انتشارًا في العالم، يرتبط بتغيرات في وظيفة الخلايا العصبية التي تتحكم بالجوع، ويؤثر على اختيار نوعية الطعام، حيث يزيد من الميل نحو الأطعمة الغنية بالطاقة مثل الدهون والكربوهيدرات.
تشير دراسة نُشرت في Nature Reviews Genetics إلى أن ما بين 40% إلى 70% من التباين في مؤشر كتلة الجسم (BMI) بين الأفراد يُعزى إلى اختلافات وراثية. وهذا يفسر لماذا يمكن لشخصين يتبعان نفس الحمية أن تكون استجابتهما مختلفة تمامًا، فالأول يفقد وزنه بسهولة، بينما الآخر يواجه صعوبة بالغة في خفض وزنه رغم التزامه.
إلى جانب العوامل الوراثية، فإن الجهاز العصبي المركزي، وتحديدًا منطقة الوِطاء (Hypothalamus)، يُعدّ مركزًا حيويًا لتنظيم الشهية وتوازن الطاقة. يتفاعل الوطاء مع عدة هرمونات مثل اللبتين (Leptin) الذي تفرزه الخلايا الدهنية لإعلام الدماغ بتوفر الطاقة، والغرلين (Ghrelin) الذي يُعرف بـ"هرمون الجوع"، والذي يرتفع قبل تناول الطعام ويحفز الشهية. وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص المصابين بالسمنة قد يعانون من "مقاومة اللبتين"، ما يؤدي إلى استمرار الإحساس بالجوع حتى عند توفر الطاقة.
تتداخل هذه العوامل الوراثية والهرمونية مع البيئة المحيطة لتنتج أنماطًا غذائية وسلوكية قد تؤدي إلى السمنة، مما يعني أن التفسير المبسط الذي يُرجع السمنة إلى ضعف الإرادة الفردية لا يعكس الواقع العلمي. فالفروق الفردية في استجابة الجسم للغذاء تُبنى على تركيبة جينية معقدة تتفاعل مع البيئة والهرمونات والمحفزات العصبية، مما يجعل من الضروري إعادة النظر في سياسات الصحة العامة التي تستند فقط إلى نصائح موحدة مثل "كل أقل وتحرك أكثر"، دون مراعاة السياق البيولوجي الفريد لكل فرد
4. البيئة الغذائية والسمنة: لماذا اللوم الفردي مضلل؟
تمثل البيئة الغذائية أحد العوامل الحاسمة في فهم وباء السمنة العالمي، إذ تشير الدراسات الحديثة إلى أن التغيرات الجذرية في توفر الطعام وطبيعته قد أسهمت في خلق ما يُعرف بـ"البيئة الغذائية السامة". هذه البيئة لا تحفّز فقط الإفراط في تناول الطعام، بل تعيق كذلك قدرة الأفراد على اتخاذ خيارات غذائية صحية ومستدامة، بغض النظر عن مستوى وعيهم أو نواياهم. وفي هذا السياق، يصبح من المضلل اختزال أسباب السمنة في اختيارات فردية أو سلوكيات شخصية منعزلة عن السياق البيئي الأكبر.
في العقود الأخيرة، شهد العالم تحولًا كبيرًا في إنتاج وتوزيع وتسويق الغذاء، حيث أصبحت الأطعمة فائقة المعالجة – الغنية بالسعرات، السكر، الدهون، والمواد المضافة – متاحة بكثرة، زهيدة الثمن، وسهلة التناول. هذا التحول لم يكن حياديًا؛ بل استند إلى استراتيجيات تسويق مدروسة تهدف إلى إثارة الرغبة والارتباط العاطفي بالطعام. وتُظهر الأبحاث أن هذه الأطعمة لا تثير فقط استجابات حسية قوية، بل تتداخل مع مراكز المكافأة في الدماغ بطريقة تُشبه تأثير المواد الإدمانية، مما يؤدي إلى استهلاك مفرط يصعب التحكم فيه.
دراسة تجريبية بارزة أجراها الباحث Kevin Hall وفريقه عام 2019، نشرت في Cell Metabolism، بيّنت أن المشاركين الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا قائمًا على الأطعمة فائقة المعالجة تناولوا بمعدل 500 سعرة حرارية أكثر يوميًا، مقارنة بمن تناولوا أطعمة طبيعية، رغم تماثل مكونات الوجبات من حيث نسب البروتين والكربوهيدرات والدهون والألياف. هذه الزيادة العفوية في الاستهلاك تؤكد أن تأثير البيئة الغذائية يتجاوز السيطرة الإرادية للفرد، ويؤثر بعمق في إشارات الجوع والشبع والتفضيلات الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب العوامل الاجتماعية والاقتصادية دورًا في تعزيز هذا التأثير، إذ ترتبط مستويات الدخل المنخفض وندرة خيارات الغذاء الصحي في بعض الأحياء، بما يُعرف بـ"صحارى الغذاء"، بزيادة معدلات السمنة. في هذه البيئات، يصبح الخيار المتاح – وليس الخيار الأفضل – هو المحرّك الأساسي للسلوك الغذائي. كما أن ضغط الوقت، والإجهاد النفسي، ونقص الدعم المجتمعي يزيد من الميل نحو الأطعمة السريعة والجاهزة، والتي تقدم حلولًا فورية للشبع دون اعتبار لقيمتها الصحية.
كل هذه العوامل تُسهم في رسم صورة أكثر تعقيدًا للسمنة، حيث لا يمكن تحميل الفرد وحده مسؤولية وزنه، ولا يمكن تفسير السمنة بأنها مجرد فشل شخصي أو أخلاقي. إن الفهم العلمي الحديث يدعو إلى تغيير في السياسات الصحية والخطاب المجتمعي، بحيث يتم التركيز على تعديل البيئة الغذائية، وتقييد تسويق الأطعمة غير الصحية، ودعم الوصول العادل إلى الخيارات الغذائية المفيدة، بدلاً من استمرار لوم الأفراد ووصمهم. السمنة، إذًا، ليست مجرد مسألة إرادة؛ بل هي نتيجة لتفاعل معقّد بين الجينات والبيئة والسلوك، يتطلب استجابة مجتمعية ونظامية لا فردية فقط.
5. قيود حساب السعرات: من الملصقات إلى الأفراد
رغم شيوع استخدام السعرات الحرارية كوسيلة لحساب الطاقة المستهلكة يوميًا، فإن الاعتماد على هذا المقياس يُعدّ مبسطًا إلى حد كبير، ويتجاهل العديد من العوامل الفيزيولوجية والسياقية التي تؤثر على دقة حسابها وفائدتها العملية. فعلى مستوى المنتجات الغذائية، تُظهر الدراسات أن الملصقات الغذائية التي تعرض "كمية السعرات" قد تكون غير دقيقة، إذ تسمح الجهات التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بهامش خطأ قد يصل إلى 20% زيادة أو نقصان عن القيمة المسجلة على العبوة. هذا يعني أن الشخص الذي يظن أنه يستهلك مثلًا 2000 سعرة حرارية يوميًا، قد يكون فعليًا يستهلك 1600 أو 2400 سعرة دون أن يدرك ذلك.
لكن المشكلة لا تكمن فقط في دقة البيانات على العبوة، بل تتعمق أكثر في اختلاف امتصاص الجسم للطاقة بحسب نوع الطعام وتركيبه ودرجة معالجته. على سبيل المثال، تُظهر الأبحاث أن الأطعمة الغنية بالألياف – مثل المكسرات أو الحبوب الكاملة – لا يتم امتصاص كامل طاقتها في الجهاز الهضمي، إذ تمر بعض المكونات عبر القولون دون تفكيك كامل، ما يجعل الطاقة الصافية المستفادة منها أقل بكثير من تلك الموجودة في الأطعمة المصنعة أو المهضومة مسبقًا. وقد بيّنت دراسة نُشرت في American Journal of Clinical Nutrition أن الطاقة التي يحصل عليها الجسم من اللوز أقل بنسبة تصل إلى 32% من تلك المقدّرة بطريقة القنبلة الحرارية (Bomb Calorimetry)، وهي الطريقة التقليدية المستخدمة في حساب السعرات.
إلى جانب ذلك، يختلف معدل الأيض الأساسي (Basal Metabolic Rate) بين الأفراد حسب الجنس، العمر، الكتلة العضلية، الحالة الهرمونية، وحتى جودة النوم، ما يجعل استهلاك السعرات واستثمارها مسألة شخصية ومعقدة لا يمكن ضبطها بمعادلة ثابتة. كما تؤثر البكتيريا المعوية في مدى كفاءة امتصاص السعرات، إذ تشير أبحاث ناشئة إلى أن بعض أنواع الميكروبيوم قد تعزز استخراج طاقة أكبر من نفس كمية الطعام مقارنة بأنواع أخرى، ما يعني أن شخصين يتناولان نفس الطعام قد يمتصان منه كميات طاقة مختلفة.
وفي سياق الحياة اليومية، نادرًا ما تكون أدوات قياس الطعام دقيقة أو موحدة؛ إذ يصعب على معظم الناس تحديد كميات الطعام المستهلكة بدقة، ناهيك عن تجاهل السعرات "الخفيّة" في الزيوت المستخدمة في الطهي أو الصلصات أو المشروبات المصاحبة. هذه الفروقات، وإن بدت صغيرة في كل وجبة، فإنها تتراكم مع مرور الوقت وتؤثر على نتائج التحكم بالوزن.
كل هذه العوامل تجعل من الاعتماد الحصري على حساب السعرات وسيلة غير فعالة، بل وقد تكون مضللة في بعض الأحيان، خاصة عند استخدامها كأداة وحيدة في برامج خسارة الوزن. الفهم العلمي الحديث يدعو إلى التركيز على نوعية الطعام، ومدى معالجته، وتأثيره الفسيولوجي، بدلاً من الاكتفاء بعدّ السعرات المجردة، التي تُخفي وراءها تعقيدًا بيولوجيًا وسلوكيًا لا يظهر في الأرقام.
6. الأيض التكيفي: استجابة الجسم لتقليل السعرات
عندما يقلل الفرد من استهلاكه اليومي للسعرات الحرارية بهدف إنقاص الوزن، فإن الجسم لا يتجاوب مع هذا النقص بشكل خطّي كما تُصور بعض الحميات، بل يُفعّل سلسلة من الآليات البيولوجية الدفاعية تهدف إلى المحافظة على الطاقة، وهي ما يُعرف علميًا بـ"الأيض التكيفي" أو Adaptive Thermogenesis. هذا المفهوم يعكس قدرة الجسم على تعديل معدلات الحرق والإنفاق الطاقي في محاولة لتقليل الفارق بين الطاقة الداخلة والطاقة الخارجة، مما يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة مع مرور الوقت رغم استمرار الحمية.
عند تقليل السعرات بشكل مفاجئ أو كبير، ينخفض معدل الأيض الأساسي (Basal Metabolic Rate)، وهو معدل الطاقة الذي يستهلكه الجسم في الراحة للقيام بالوظائف الحيوية كتنظيم درجة الحرارة، ضخ الدم، وتنفس الخلايا. هذا الانخفاض لا يُعزى فقط إلى نقص الوزن، بل يتجاوز التوقعات الحسابية، وهو ما يجعل الجسم يدخل في "وضع المحافظة" ويُصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وأقل سرعة في حرقها. يُضاف إلى ذلك انخفاض في مستويات اللبتين، وهو الهرمون الذي تفرزه الخلايا الدهنية ويُرسل إشارات إلى الدماغ بالشبع وكفاية الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالجوع مع كل انخفاض في الوزن.
أظهرت إحدى أبرز الدراسات الطولية التي تابعت متسابقي برنامج "The Biggest Loser" أن معظم المشاركين واجهوا انخفاضًا حادًا ودائمًا في معدل الأيض حتى بعد مرور ست سنوات من انتهاء البرنامج، وهو ما فسر عودة الوزن لدى الغالبية رغم استمرارهم في محاولات التنظيم الغذائي والتمرين البدني (Fothergill et al., 2016). هذا يُشير إلى أن الجسم لا "ينسى" بسرعة مرحلة التجويع، بل يعيد برمجة آليات الحرق لديه بشكل طويل الأمد، مما يخلق تحديًا بيولوجيًا مستمرًا أمام من يسعى لإنقاص الوزن.
بالإضافة إلى الأثر المباشر على التمثيل الغذائي، يترافق الأيض التكيفي مع تغيرات في النشاط اليومي غير المرتبط بالتمارين (NEAT) مثل الحركة العفوية أو الجلوس أو الوقوف، والتي تقل تلقائيًا عندما يكون الجسم في حالة نقص طاقي. كما ينخفض إفراز هرمونات الغدة الدرقية مثل T3 التي ترتبط بزيادة معدل الحرق، وهو ما يُعزز الركود الأيضي ويجعل من الاستقرار على وزن منخفض مسألة معقدة بيولوجيًا أكثر من كونها إرادة شخصية.
هذه الظاهرة توضّح أن خسارة الوزن ليست مجرد حساب رياضي للسعرات، بل معركة هرمونية وبيولوجية متشابكة، تستدعي فهمًا دقيقًا للطريقة التي يعمل بها الجسم، والابتعاد عن الحميات الصارمة قصيرة الأمد التي تُضعف الحرق وتزيد احتمالات الاسترجاع السريع للوزن. وبدلاً من ذلك، تُشير الأدلة إلى أهمية اعتماد استراتيجيات غذائية تدريجية، متوازنة، ومستدامة، تُقلل الضغط الأيضي وتحافظ على وظائف الجسم الطبيعية دون دفعه إلى حالة الطوارئ الطاقية.
7. نحو إعادة تعريف العلاقة مع الطعام
إن أحد أهم التحولات الفكرية التي تطرحه الأدبيات العلمية الحديثة في مجال السمنة والتغذية هو الدعوة إلى إعادة تعريف العلاقة مع الطعام، بعيدًا عن الخطاب القائم على اللوم، أو القواعد الصارمة التي تضع الإنسان في حالة دائمة من الصراع مع نفسه ومع الغذاء. تقليديًا، اعتُبر الطعام إما وسيلة للبقاء أو أداة للمتعة أو سببًا للمشكلة، لكن هذا التصنيف الثنائي أثبت قصوره في التعامل مع الواقع المعقد للإنسان الحديث الذي يتعرض لمزيج من الضغوط النفسية، والمحفزات البيئية، والتغيرات الهرمونية.
إن الاعتماد المطلق على حساب السعرات الحرارية، ومحاولة التحكم بالجسم من خلال معادلات طاقة جامدة، تجاهل الطابع التفاعلي بين العقل، والعاطفة، والسلوك الغذائي. تشير دراسات في علم النفس العصبي والسلوك الصحي إلى أن التركيز المفرط على "التحكم" و"المنع" يرتبط بزيادة الأفكار الوسواسية حول الطعام، ونوبات الإفراط، والشعور بالذنب، مما يخلق دورة معاكسة للهدف الأساسي، ويزيد من خطر اضطرابات الأكل.
في هذا السياق، برزت مفاهيم جديدة في علوم التغذية تُعرف بـ "التغذية الحدسية" (Intuitive Eating) و**"التغذية الواعية" (Mindful Eating)**، وهي مناهج تقوم على استعادة الثقة في إشارات الجسم الطبيعية للجوع والشبع، والتمييز بين الأكل الفيزيولوجي والعاطفي، وتحرير الإنسان من علاقة الصراع مع الطعام. هذه المناهج لا تركز على الوزن كمؤشر أولي، بل على تحسين جودة الحياة، وتعزيز الوعي الذاتي، وتبني سلوكيات غذائية مستدامة بغض النظر عن شكل الجسم.
إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز العلاقة الصحية مع الطعام يتطلب معالجة البنية الاجتماعية والاقتصادية المحيطة، بحيث لا يكون الوصول إلى الغذاء الصحي امتيازًا، بل حقًا متاحًا للجميع. ذلك يشمل إعادة تصميم البيئة الغذائية، والحد من تسويق الأطعمة عالية المعالجة للأطفال، وتوفير بدائل صحية مقبولة من حيث السعر والطعم.
وأخيرًا، إن أي محاولة جادة لمكافحة السمنة يجب أن تتجاوز النظرة الطبية الضيقة التي ترى في الوزن مجرد رقم يجب خفضه، إلى نظرة إنسانية شاملة تعترف بأن الطعام ليس فقط مغذيًا أو محرضًا للسمنة، بل هو جزء من الهوية والثقافة والانفعالات الشخصية. ولذلك، فإن الحلول الفعالة تبدأ بإعادة صياغة العلاقة مع الطعام باعتباره شريكًا في الصحة لا عدوا يجب مقاومته، وهو تحول يتطلب مزيجًا من الفهم العلمي، والوعي المجتمعي، والتعاطف الفردي.
خاتمة
إن فهم السمنة والتغذية يتطلب منهجًا بيولوجيًا شاملاً يتجاوز الأرقام السطحية للسعرات الحرارية. تشير الأدلة العلمية، كما يوضح Giles Yeo، إلى أن التركيز على "السعرات فقط" يُبسط قضية معقدة ويديم مفاهيم غير منصفة. المطلوب هو تحول في التفكير العام والسياسات نحو فهم أعمق للبيولوجيا البشرية، وتحسين البيئة الغذائية، وإيجاد استراتيجيات مستدامة تُراعي الفروق الفردية.