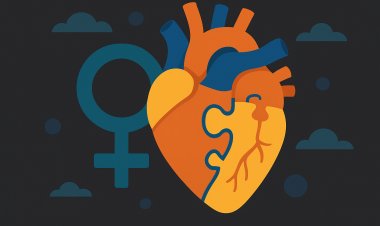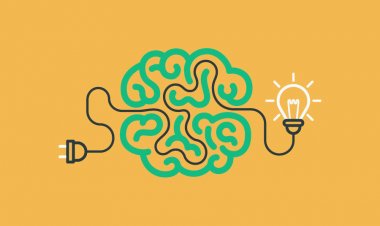من يملك صوت التوعية اليوم؟ المختصون أم الناقلون؟
تأمل تحليلي في تحوّل التوعية من أروقة الاختصاص إلى فضاءات النشر المفتوح، مع إبراز التحديات بين المختصين والناقلين، ودور الجمهور في التمييز بين العمق والمظهر في زمن تتشكل فيه المعرفة خارج القاعات الأكاديمية.

التوعية بين الماضي والمستقبل
من اختصاصي يتحدث إلى ناقل يتصدر
في زمنٍ لم يكن فيه الوصول إلى المعلومة ميسورًا، ولم يكن للناس نافذةٌ إلا عبر شاشات التلفاز أو موجات الأثير، كانت التوعية فعلًا مؤسسيًا منظمًا، تسبقه دعوة رسمية، وتُنسج حوله هالة من التقدير والاحترام، إذ يُستضاف المختص في مجاله، لا ليُعبّر عن رأي شخصي أو انطباع ذاتي، بل ليقدم علمًا موثوقًا، مستندًا إلى دراسات وتجارب، ومتحدثًا بلسان المهنة لا لسان المزاج. كان ظهوره حدثًا توعويًا بحد ذاته، وكان الجمهور يتعامل مع صوته وكلماته كما يتعامل مع الخبر اليقين. لم تكن التوعية فعلًا شعبيًا، بل ممارسة رصينة يشرف عليها إعلاميون محترفون، ويُنتقى ضيوفها بدقة، ويُهيَّأ لها سياقها الزمني والمكاني، حتى لا تخرج إلا محكمة البناء، واضحة المعنى، دقيقة الدلالة.
لكن الزمن تغير. وتبدلت الأدوات، لا بل تكسّرت الحواجز وانفتح الباب على مصراعيه. لم تعد القنوات وحدها من يختار من يرفع راية التوعية، بل صار كل هاتف ذكي منصة إعلامية، وكل فردٍ ــ مهما ضاق اختصاصه أو اتسع ــ قادرًا أن يتكلم في كل شيء، وأن يُصدر الأحكام، ويصوغ المفاهيم، وينقل للناس ما يراه توعويًا دون سؤال أو مساءلة. لم تعد التوعية حكرًا على الطبيب أو المختص أو الأكاديمي، بل أصبحت فعلاً شائعًا يمارسه المؤثرون، وتُتداول فيه المعلومات كما تُتداول الإشاعات، بين سرعة النشر، ورغبة في التفاعل، وشهوة الوصول.
وهنا، تتضح الفجوة بين "الاختصاص" و"النقل"، بين من يفهم جذور المعلومة وبنيتها وسياقها، وبين من ينقلها كجملة جذابة تُرضي المتلقي لا العقل. لم يعد الفارق في المعلومة ذاتها، بل في قدرة الناقل على فهم المصدر، وعلى تمييز جودة المراجع، وعلى احترام تعقيد المفاهيم العلمية قبل تبسيطها. وهنا يظهر الفرق الحاسم بين من يختصر لك الطريق نحو الفهم، ومن يقودك بعبارته نحو وهم الإدراك.
في هذا التحول، لا يكمن الخطر في كثرة المتحدثين، بل في اختفاء المرجع، وانحسار صوت المختص وسط ضجيج العامة. لقد أصبحنا أمام مشهد معرفي جديد، فيه التوعية ليست بالضرورة أصدق، بل أوسع انتشارًا… فهل هذا التوسع فتحٌ للوعي؟ أم اتساعٌ في سطحية الفهم؟
صراع الصوتين… حين يتفوّق الناقل على المختص
لقد بات النقل واقعًا لا يمكن نكرانه، لا بل أصبح أسرع من أن يُلحق، وأوسع من أن يُحاصر، وأقوى من أن يُتجاهل. فبينما كان المختص في الماضي يخطو بخطى منهجية بطيئة نحو الجمهور، عبر موافقات مؤسساتية ومواعيد بثّ رسمية، أصبح الناقل ــ بلمسة إصبع ــ قادرًا أن يوصل ما يريد إلى آلاف، بل ملايين المتابعين، خلال دقائق، دون أن ينتظر دعوة، أو يخضع لتحرير، أو يُقيد بضوابط الإنتاج الأكاديمي أو الإعلامي.
ولم يكن غريبًا أن يشعر بعض المختصين بالاستفزاز، بل بالتهديد. فهم يرون في هذا المشهد الفوضوي خروجًا عن القواعد، وإهانةً للمسار العلمي الذي قضوا فيه أعمارهم. يرفع بعضهم صوته استنكارًا: "من سمح له أن يتكلم؟ بأي حق يتصدر؟" فيرد عليه الواقع بلا استئذان: الناس هم من اختاروه. وهنا يتجلى المفارقة الموجعة: المختص يملك العلم، لكن الناقل يملك الوصول.
وكم هو مؤلم أن يحاول بعض أهل التخصص "منع" هؤلاء من الحديث، وكأنهم بذلك يحاولون حجب الشمس بكف اليد؛ لا لأن الناقلين هم دائمًا الأصح، بل لأنهم أصبحوا جزءًا من نظام الواقع الجديد، تمامًا كما لم تستطع الصحف أن تمنع ظهور المدونات، ولا الفضائيات أن توقف زحف منصات الفيديو. إنها سنة التحول لا المجاملة.
بل الأدهى من ذلك أن بعض الناقلين ــ بحكم قدرتهم على التبسيط، وفهمهم العميق لاحتياجات الجمهور، وموهبتهم في الصياغة والعرض ــ أصبحوا يقدمون المعلومة أفضل من بعض المختصين، لا من حيث صحتها العلمية فحسب، بل من حيث أثرها وفهمها وبقائها في ذهن المتلقي. لقد غلبت البلاغة الجافة، والطرح المعقد، واللغة المتعالية التي ما زال بعض المختصين يتوسدها، وينسى أن العلم لا يبلغ غايته إلا إذا عبر الجسر إلى الناس.
فهل الناقل الجيد خطر؟ أم فرصة؟ وهل على المختص أن يقف في وجهه؟ أم أن يبحث عن صوته من خلاله؟
هنا تتغير قواعد الصراع: لم يعد السؤال "من يحق له أن يتكلم؟"، بل "من يستطيع أن يُقنع ويُنوّر دون أن يُضل؟"
مستقبل التوعية... حين يصبح الناقل هو البوابة والمعبر
في المدى الذي يرسمه الأفق القادم، يبدو أن التوعية لن تعود مرتبطة بالمختص كما كانت، بل ستنبثق من حراك الناقلين، أولئك الذين لا يحملون شهادات علمية بالضرورة، لكنهم يحملون شيئًا لا يُمنح في قاعات المحاضرات: الفهم الشعبي، والبساطة المؤثرة، والقدرة على تحويل المعلومة إلى قصة، والصيغة الجافة إلى معنى نابض بالحياة. التوعية المقبلة ستكون توعية بلا بطاقة تعريف، بلا رتبة أكاديمية، وإنما بعين على الجمهور، وأذن تُصغي لاحتياجاته، ولسان يعرف كيف يُدخل العلم إلى القلب قبل العقل.
صحيح أن المختص لا يُقصى تمامًا، بل يمكن له أن يُعيد إنتاج ذاته كناقل، وأن يُعيد تقديم علمه في قوالب أكثر وصولًا، لكنه إن تمسك بدائرته الضيقة، ولم يتجاوز حدود تخصّصه، فإنه سيبقى في حيزه، يتحدث إلى قلة تُشبهه، بينما الناقلون يصنعون أمواجًا من التأثير، تتجاوز التخصصات، وتُمسك بزمام الرأي العام.
وهنا تنشأ إمكانية التكامل لا الإقصاء: المختص يُغذي، والناقل يُبسط، المختص يُقوّم، والناقل يُوزع، المختص يحرس المعنى، والناقل يوصله حيث لا تصل الأبحاث ولا المؤتمرات. ذلك هو النموذج المنشود، الذي لا يتعالى فيه المختص على الناقل، ولا يتوهم الناقل أن التأثير يُغني عن الدقة.
ومع هذا التحول، سينتقل عبء التمحيص من مصدر المعلومة إلى مستقبلها. فالناس، في هذا الفضاء المتخم بالمحتوى، لن يُقال لهم: "اسمعوا لهذا، وابتعدوا عن ذاك"، بل سيكون عليهم أن ينقّبوا، أن يُقيّموا لا فقط بالعين التي ترى المظهر، أو الأذن التي تطرب للأسلوب، بل بالعقل الذي يتأمل: هل ما قيل له جذر؟ هل لهذا القول مرجعية؟ هل هذا التأثير مغطّى بالفهم أم أنه زخرف خادع؟
بل إن المؤسسات، تلك التي تنفق الملايين في حملات لا تتجاوز خط البداية، ستجد نفسها مرغمة على مراجعة قواعد اللعب. لن تعود الاستراتيجيات التقليدية في التوعية كافية، تلك التي تبدأ بتصميم جذّاب وتنتهي عند بوستر لا يُقرأ. بل سيتحول النقل التوعوي إلى اقتصاد صغير، بل إلى سوق متكامل، تُستثمر فيه الميزانيات بذكاء: ليس في شعارات فارغة، بل في محتوى يُنتج ويُقدّم ويُتابع ويُقاس أثره.
في المستقبل، لن تكون التوعية وظيفة إعلامية، بل ستكون منظومة تأثير. الناقل فيها ليس هاويًا، بل محترف. والمختص ليس معزولًا، بل مشارك متكامل. والجمهور ليس متلقيًا سلبيًا، بل شريكًا في التنقيح والتقييم والاختيار.